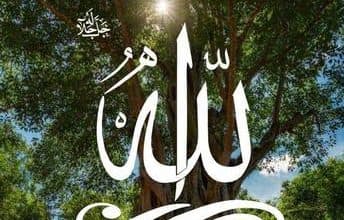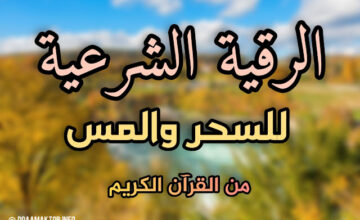التاريخ الهجري هوية أمة وتاريخ حضارة

لكل أمة تقويمها الخاص الذي تعتزّ به، والذي يعتبر جزءاً أصيلاً من هويتها وتاريخها؛ والأمة الإسلامية كباقي الأمم، لها تقويمها الخاص الذي يعود بها إلى ذكرى مهمّة، غيرت مجرى التاريخ فهو يرمز إلى الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة ؛ حيث أسّس رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه من المسلمين الصابرين نواة الدولة الإسلامية التي ما لبثت وأن صارت قوّةً عالميّةً عظمى تتفوق على أقوى قوتين عالميتين في ذلك الوقت وهما: الفرس، والروم.
تاريخ التقويم الهجري
كانت العرب تؤرخ للسنوات بالأحداث الكبيرة ، فتقول :عام الفيل ، عام الطاعون ( طاعون عمواس ) ، وعام الرمادة ..وهكذا.
والمشهور أن أول من أرخ بالهجرة في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة سبع عشرة للهجرة، وبداية ذلك أنه أتت رسالة لأبي موسى الأشعري، أمير البصرة في خلافة عمر، مؤرخاً في شهر «شعبان»، فأرسل إلى الخليفة عمر، يقول: «يا أمير المؤمنين تأتينا الكتب، وقد أرخ بها في شعبان ولا ندري هل هو في السنة الماضية أم السنة الحالية».
قال ابن حجر في فتح الباري: “وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء: منها ما أخرجه أبو نعيم في تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي: “أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرِّخ بالمبعث، وبعضهم: أرِّخ بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرِّخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة. فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدءوا برمضان، فقال عمر: بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه”
وروى البخاري في “الأدب”، والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رُفِع لعمر صك محله شعبان فقال: أي شعبان، الماضي أو الذي نحن فيه، أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئا يعرفونه فذكر نحو الأول.
فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وبعضهم أرخ بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة.
وعلى الرغم من أن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة كانت في 22 ربیع الأول الموافق عام 622 م، إلا أنهم بدأوها من شهر المحرم وذلك لأن شهر محرم كان بدء السنة عند العرب قبل الإسلام ولأنه أول شهر يأتي بعد منصرف الناس من حجهم الذي هو ختام مواسم أسواقهم.
فطنة الصحابة لأهمية الهجرة :
لقد فَهِم الصَّحابة – رضي الله عنهم – قيمَة الهِجرة النبويَّة، فجَعلوها مبدأً للتأريخ، فلم يُؤرِّخوا بمولِده ولا ببعثَتِه – صلَّى الله عليه وسلَّم – ولا بغزْوة بدر التي سجَّلتْ أول انتِصارٍ للإسلام على الشرْك والمُشرِكين، ولا بفتْح مكَّة الذي طهَّر الله به البيتَ الحرام مِن عِبادة الأوثان.
إنَّ كل هذه الأحداث تَصلُح لأنْ تكون مبدأً للتأريخ الإسلامي، لولا ما يَقترن بكل منها مِن معنى يتَضاءل أمام ما تَحمِله الهجرة مِن أحداث ودروس مُستفادة ونتائج إيجابيَّة.
فالميلاد – ميلاد المُصطفى – صلَّى الله عليه وسلَّم – وإن كان هو مبدأ انبثاق النور المحمَّدي، إلا أنه ربَّما صرَف الناس إلى الاهتمام بذات الشخْص، والإسلام دين مبادئ لا دين أفراد، دين يَربط المسلم بربِّه مُباشرة، ولا يَصرفه لعبدٍ مِن عِباده وإن كان خير خلْق الله – صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
أما البعْثة، فهي في الحقيقة أولُ مَظهر تجلَّت فيه عِناية الرحمن بهداية الخلْق مِن جديد، بعد أن انحرَفوا عن الصراط المُستقيم، ومع ذلك فإنَّ البعْثة لم يتحقَّق المُراد منها إلا بعد الهجرة.
كذلك وقْعة بدر وفتح مكة، فإنهما معركتان هامتان، أذلَّ الله بهما الكفْر ودولته، ومكَّن المسلمين في أعقابهما مِن عدوِّهم تمكينًا، إلا أننا لو نظرْنا بعَين الواقع لوجدْناهما مِن ثمرات الهجرة.
فالهجرة إذًا هي المَوقِف الحاسم في تاريخ الإسلام، وكل ما تحقَّق بعدها مِن نجاحات فهو محسوب لها، وراجِع إليها.
فهم الصَّحابة – رضي الله عنهم – أنَّ الهجرة عمل جماعيٌّ اشتَرك فيه رسول الله – صلَّى الله عليه وآله وسلَّم – وأهلُ بيتِه، وصَحابته، وفقراء المسلمين وأغنياؤهم، ورجالهم ونِساؤهم، وصَغيرهم وكبيرهم، وحُرُّهم وعبْدهم، الكل في بِناء الدولة سواء، ميزانُهم في التمايز ميزان مُطلَق: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وهنا ذابَت العصبيَّاتُ والعُنصريات والقبَليات في بُوتقة الإيمان والعمل الصالح، وهذا أساسٌ للنجاح في كل عملٍ، وهذه دعوة الإسلام.
فَهِمَ الصَّحابة – رضي الله عنهم – كيف فرَّقت الهجرة بين عهدَين؛ عهد مكَّة، الذي كانوا يخافون فيه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولا يَقدِرون على مُمارسة شعائر دينِهم، وذاقوا فيه أشدَّ أنواع التنكيل؛ فقُتِّلوا وشُرِّدوا وأوذوا وحوصِروا وعُذِّبوا، وما آل ياسر وبلال وخبَّاب – وغيرُهم الكثير – عنَّا ببعيد، بل طال هذا الإيذاء النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وعهد المدينة، وعجبًا لهؤلاء القوم الذين خرَجوا فرارًا بدينهم، بعد مدَّة يسيرة مِن الهجرة يعودون إلى مكَّة فاتِحين مُنتصِرين، ويَزأَر مُؤذِّنهم فَوق الكعبة: الله أكبر.
لهذا اتَّخذ المسلمون الأوائل الهجرة عنوانًا للتقويم الإسلامي؛ ليُرسلوا رسالةً إلى كل مسلم على رأس كل عام هجريٍّ: اقرأ تاريخك واحفَظْ هذا التاريخ؛ فمَن ليس له ماضٍ، ليس له حاضِر، ولن يكون له مُستقبَل.
ليُرسلوا رسالةً إلى كل مسلم: هذا الدين أمانة في أعناقكم؛ فحافظوا عليه ولا تُضيِّعوه.
ليُرسلوا رسالةً إلى كل مسلم: هذا ما قدَّمه المسلمون الأوائل للإسلام، فماذا قدَّمتَ أنت؟
أشهر التقويم الهجري
يتكون التقويم الهجري من 12 شهر قمري كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم في: (إِنَّ عِدَّةَ الشهورعند اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) الآية (36) من سورة التوبة
والسنة الهجرية تساوي 354 يوما تقريباً، يبدأ كل شهر هجري مع بداية وقت القمر الجديد، حيث يكون تعداد أيام أشهر التقويم الهجري حسب دورة القمر حول الأرض، وتتناوب الأشهر بين 29 و30 يوماً، فالفارق بينها وبين السنة الميلادية 11 يوم .
الإعجاز في قوله تعالى: “ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وَازْدَادُوا تِسْعًا “الكهف:25.
هذه الآية من الإعجاز العلمي في كتاب الله، فثلاثمائة عام ميلادي تساوي بالضبط ثلاثمائة وتسع سنوات هجرية”، فالله عزَّ وجل بين المدة على التقويمين، الشمسي، والقمري.﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ﴾ هذا بالسنة بالشمسية
﴿وَازْدَادُوا تسعا على التقويم القمري، وليسَ الهجري، إذّ لم يَكُن وقتها تقويم هجري.
لِمَ قال هكذا: (وازدادوا) ألم يكن كافياً أن يقال: ثلاثمائة وتسع سنوات؟
فالجواب: هناك السنة القمرية، وهناك السنة الشمسية، فهي ثلاثمائة عام شمسية، وثلاثمائة وتسعة أعوام قمرية. والقرن الشمسي يزيد عن القرن القمري بثلاث سنوات في كل مائة عام، فكل مائة سنة شمسية تساوي مائة وثلاث سنين قمرية، فهي ثلاثمائة عام شمسية، وثلاثمائة عام وتسعة أعوام قمرية، ومعنى القمرية: أننا نعد أشهرها برؤية القمر.
وكأن الله أراد أن يقول: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا [الكهف:25]؛ لأن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هم أهل قريش، الذي أرشد قريشاً إلى أن تسأل هم أهل الكتاب، فأراد الله أن يقول: لبثوا ثلاثمائة سنين بحسب من أرشد وهم أهل الكتاب بالسنة الشمسية، وَازْدَادُوا تِسْعًا على الثلاثمائة بحساب من سأل وهم: قريش الذين يحسبون بالسنة القمرية، وهذا الجواب لا يقدر عليه إلا الله الذي أحاط بعلم أهل الكتاب، وبعلم قريش؛ لأن العلم بالفوارق بين السنين الشمسية والقمرية قلما يهدى إليه كل واحد ، لكن الله تبارك وتعالى علم نبيه ما لم يكن يعلم، وإلا فإن علم الله أعظم من ذلك وأجل.
تقسيمات الشهور الهجرية
قسم العرب الشهور الهجرية إلى قسمين كالتالي:
– الأشهر الحُرُم: وعددها أربعة، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. وسميت بالأشهر الحرم لأن القتال كان محرماً فيها عند العرب في الجاهلية، ولعل هذا مما توارثوه عن الخليل إبراهيم، وبقي الحال على ما هو عليه بعد الإسلام فأقرهم عليها.
وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) رواه البخاري.
– الأشهر الحِلُ: وهي بقية الأشهر الهجرية ، وسميت بالأشهر الحِلُ لأن القتال فيها كان حلالاً عندهم.
معنى اسماء الشهور في التقويم الهجري:
رغم أن التقويم أنشئ في عهد المسلمين إلاّ أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كان تستخدم منذ أيام الجاهلية، وارتبط اسم كل شهر بمعنى أو سبب أو زمن كما ذكر المؤرخون، ويبدو أنها سميت على أزمنة متفاوتة أو كان كل قبيلة لها مسمياتها الخاصة ثم استقرت قريش على هذه الأسماء بدليل تسمية شهر ربيع بهذا الاسم الذي يدل على فصل الربيع ثم جمادى بعده لوقوعه في الشتاء، رغم أن الشتاء أولا ثم يأتي الربيع بعده ، ثم تسمية رمضان بعدهما بشهرين لأنه كان يقع في الحر الشديد ، ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الأشهر الحرم ” وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ” قال العلماء في شرح الحديث : وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ هَذَا التَّقْيِيدَ مُبَالَغَةً فِي إِيضَاحِهِ وَإِزَالَةً لِلَّبْسِ عَنْهُ، قَالُوا وَقَدْ كَانَ بَيْنَ بَنِي مُضَرَ وَبَيْنَ رَبِيعَةَ اخْتِلَافٌ فِي رَجَبٍ فَكَانَتْ مُضَرُ تَجْعَلُ رَجَبًا هَذَا الشَّهْرَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَكَانَتْ رَبِيعَةُ تَجْعَلُهُ رَمَضَانَ فَلِهَذَا أَضَافَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُضَرَ، إذن فمن الواضح تعدد أسماء الشهور في القبائل العربية ثم استقر الأمر على هذه الأسماء التي بلغتنا وهي على النحو التالي :
- محرّم: وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأنهم كانوا يحرّمون القتال فيه.
- صفر: سمي صفراً لأن ديار العرب كانت تصفر أي تخلو من أهلها للحرب.
- ربيع الأول: سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمه ذلك الاسم.
- ربيع الآخر: سمي بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأوّل.
- جمادى الأولى: وسميت جمادى لوقوعها في الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء.
- جمادى الآخرة: سمي بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.
- رجب وهو من الأشهر الحرم. سمي رجباً من الترجيب وهو التعظيم، يقال رجب الشيءَ أي هابه وعظمه.
- شعبان: لأنه يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء. وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أي تتفرق)؛ للحرب بعد قعودهم في شهر رجب.
- رمضان وهو شهر الصّوم عند المسلمين. سُمّي بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التي سمي فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.
- شوال وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت “أي نقصت وجف لبنها”، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.
- ذو القعدة وهو من الأشهر الحرم: سمي ذا القعدة لقعودهم في رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.
- ذو الحجة وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم. سمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج في هذا الشهر.
أهمية التأريخ الهجري:
أولا / يقوم على التاريخ الهجري ثلاثة من أركان الإسلام ، هي :
1- الزكاة :فحول الزكاة في الأموال، وغيرها هو سنة هجرية كاملة .
2- الصوم : في شهر رمضان وهو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية .
3- الحج : في شهر ذي الحجة ، وهو الشهر الثاني عشر من الأشهر الهجرية.
وهناك كثير من العبادات؛ مرتبطة بالتاريخ الهجري، مثل: عدة المرأة حال وفاة زوجها، الأضحية، والسنن التطوعية، مثل: صيام ستة أيام من شوال، صيام الأيام البيض، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، وغيرها من العبادات. صيام عاشوراء.
ثانيا / التاريخ الهجري رمز الهوية الإسلامية:
يُعدّ التاريخ الهجري بمثابة رمز وهوية للأمة الإسلامية، حيث يرتبط التاريخ الهجري بهجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث كانت الهجرة المنطلق الذي بدأ منه تكوين الأمة الإسلامية، وترتبط الأحداث التاريخية الإسلامية العظيمة بالأشهر الهجرية، ومثال ذلك الانتصارات والفتوحات الإسلامية في غزوة بدر، وفتح مكة، ومعركة حطين، ومعركة عين جالوت، وغيرها من المعارك الإسلامية.
والواقع أن الأمَّة الإسلاميَّة لا ترتبط بتاريخها أو تقويمها الهجري إلا في حالات الازدهار والرقي والتقدم، وحينما يتحقق لها واقعيًّا مرتبة الشهود الحضاري على الأمم كما أراد لها القرآن الكريم.
وإذا تتبعنا تاريخنا وتقويماتنا التاريخيَّة وجدنا أن ما قبل سقوط الخلافة العثمانية كان يُؤرخ له بالتاريخ الهجري أو قبل سقوطها بقليل ، فكان يُؤرّخ للأحداث والمعارك والوقائع والمواليد والوفيات بالتاريخ الهجري.
وما من شكّ في أن التاريخ الهجري هو هوية أمة، وتاريخ حضارة امتدت عبر ثلاثة عشر قرنًا من الزمان لم نكن نؤرخ فيها إلا بهذا التاريخ، ومن هنا ارتبطت أمجادنا وأيامنا ومآثرنا بهذا التاريخ الذي تحوَّلنا عنه إلى غيره نتيجة لأحوالنا وأوضاعنا، كأثر من آثار الغزو الفكري الذي امتدَّ في فراغنا.
ولا يحسبنَّ أحد أن المسألة هامشيَّة أو فرعية بحيث يعد الحديث عنها نوعًا من اللهو أو الترف الفكري في الوقت الذي تعاني فيه الأمة ما تعاني مما يمكن أن نهوِّن به من هذا الأمر، فقد استمرت المؤامرة لطمس التاريخ الهجري وإزالته وتجهيل الشعوب الإسلاميَّة به قرونًا متوالية .
سبب التحول من التاريخ الهجري إلى الميلادي:
في القرن الثامنَ عشر الميلاديِّ عندما أرادَت الدولة العثمانيَّةُ تحديثَ جيشها وسلاحها، طلبَتْ مساعدةَ الدُّول الأوربيَّة ؛ (فرنسا، وألمانيا، وإنكلترا… إلخ)، فوافَقوا على مُساعدتِها بشروطٍ؛ منها: إلغاء التقويم الهجريِّ في الدَّولة العثمانيَّة، فرضخَتْ لضغوطهم، في القرن الثاني عشر الهجري وتحديدا عام 1290هـ ، لكن بقي التاريخ الهجري بمصر- رغم أنها كانت جزءا من الخلافة العثمانية آنذاك – حتى عهد الخديوي إسماعيل لما أراد أن يَستقرض مبلغًا من الذَّهَب من إنجلترا وفرنسا؛ لِتَغطية مصاريف فَتْح قناة السويس، اشترطَتا عليه ستَّة شروط؛ منها: إلغاء التقويم الهجريِّ في مصر؛ فتمَّ إلغاؤه سنة 1875م.